نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«وحيد حامد».. فارس الدراما و«معلم» فن كتابة السيناريو (1-2), اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:57 مساءً
كان مشروعاً أريد تحقيقه، وهو إجراء مناقشات مطولة مع صناع السينما، يتحدثون خلالها عن الفكرة.. القصة والحوار، عن الواقع والخيال والخبرات الحياتية والدراسة، عن الأفلام وكواليسها.. عن الحياة. ومنذ سنوات، قررت البدء فى الرحلة السينمائية، والبداية كانت مع التأليف والكتابة، بعمل حوارات مع كبار كتاب السيناريو فى مصر، بطريقة مختلفة لا تعتمد على مجرد السؤال والإجابة، لكنها تناقش تجربة مصرية مميزة، من خلال الغوص داخل «دماغ» كل مبدع.. ونقلها للقارئ فى لقاءات نُشرت فى كتاب «أول الحكاية»، الصادر عن دار معجم، يعرض اختلاف وجهات نظرهم، أفكارهم، طرقهم فى الكتابة.
وعندما كان «أول الحكاية» مجرد «فكرة» أنشغل بها طوال الوقت، لا تخرج من رأسى، حكيتها لزميلى وصديقى الصحفى إمام أحمد فتحمس لخوض التجربة معى.. لتخرج لقاءات مع كبار صناع السينما بينهم وحيد حامد، بشير الديك وغيرهما.. وهو ما تنشره «الوطن» لأول مرة صحفياً وإلكترونياً إيماناً منها بأهمية الثقافة وصناعة السينما وتأثيرها على المجتمع.. وتبدأ بنشر حوار الكاتب الراحل عاطف بشاى. وهو ما حمسنى لإجراء مناقشات أخرى مع المؤثرين فى «السينما» استكمالاً للمشروع الذى بدأته. وفى اللقاء تحدث وحيد حامد عن فيم يفكر الكاتب؟، كيف يصنع الدراما؟، من أين جاء بشخصيات أفلامه؟، كيف كتب الحوار؟، كيف يخلق على الورق؟، عن الغموض والمعالجة، عن علاقة السيناريست بالمنتج والمخرج والممثل والجمهور، عن النسخة الأخيرة من السيناريو. فتح قلبه، وقدم نصائحه للشباب المبدع، وتحدث عن تجاربه الملهمة، بداية من أول الحكاية، مروراً بالمشوار المهم والملهم والذى له كبير التأثير على السينما والمجتمع.


كان اللقاء مع الكاتب الكبير، عام 2018، بداية سلسلة حوارات أول الحكاية، والأحاديث المطولة مع صناع السينما.. وصلنا قبل الموعد بنحو 15 دقيقة حتى نكون فى انتظار الأستاذ، لكن بمجرد وصولنا فوجئنا به يجلس على منضدته المطلة على نهر النيل داخل أحد فنادق القاهرة. كان جالساً بين أوراقه الكثيرة وبعض الكتب ومجموعة من الأقلام بألوان حبر متنوعة، وعلى يساره أحد المؤلفين الشباب الذى كان يمعن الاستماع إلى النصائح التى يُردّدها الأستاذ، ومن حوله يستمع آخرون. فكرنا الانتظار بعيداً لبعض الوقت حتى ينتهى من جلسته، لكن بعد أن صافحنا طلب منّا الجلوس على المنضدة نفسها، ثم أشار إلى الجرسون لمضايفتنا، كان المكان مُبهجاً، أمتار قليلة تفصلنا عن مياه النيل، الهواء منعش للغاية، وعلى امتداد البصر نرى الأشجار والورود وأنواعاً من الطيور تحلق بالقرب من المكان، انتهت مناقشته مع الزائر الشاب، ثم بدأت المناقشة التى جئنا من أجلها.
بابتسامة ودودة، قال الأستاذ: منورين يا شباب.. سعيد بيكم.. اتفضلوا اسألوا كل الأسئلة اللى نفسكم فيها.
الكُتّاب أحباب الله
الكتابة بشكل عام، تعتبر نعمة من الله، يخص بها الأخيار، من يحبهم، بمعنى إذا أحب الله إنساناً يُحببه فى الكتابة، لكنها تستدعى من صاحبها وفرة الخيال، الحلم، الرؤية الواسعة والثقافة الكبيرة جداً والمتنوعة.
الكتابة مجرد جنين.. يكبر باتساع الثقافة
أثناء دراستى فى المرحلة الإعدادية، كنت أكتب ما أعتقد أنه جيد، لكنها كانت محاولة المبتدئ، وكنت أرسل ما أكتبه إلى من هو أكبر منى علماً ووعياً، على أمل سماع كلمة طيبة، كنت أحاول كتابة القصة القصيرة، وكانت تعتبر مجرد تطور لموضوع إنشاء، فكانت الكتابة مثل الجنين، الذى كبر معى باتساع الثقافة والتى أعتبرها وقود الكاتب.
الأدب العالمى ومسرحيات «المعلم الكبير»
لم أبدأ فى كتابة «ديالوج»، حوار، أو تمثيلية إذاعية، إلا بعد قراءة عدد لا يُحصى من المسرحيات العالمية، وانفتحت على ثقافات مختلفة، وكنت أنتقل من الأدب الروسى، إلى الفرنسى، إلى الأمريكى، وأرى أن لقراءة المسرح أهمية كبرى للكاتب، لأنها تمكنه من كتابة جمل حوارية جيدة، وأتحدى أى شخص قرأ مسرحيات شكسبير كلها، ثم يكتب حواراً بعدها، بأن النتيجة النهائية لكتابته ستكون 10 على 10، لأنه زود الوقود بالنموذج الأمثل.
وفى بعض الأحيان أرى أن قراءتى فى البدايات لشكسبير تعتبر غلطة، لأننى بدأت بـ«المعلم الكبير»، الذى يتعلم منه الجميع، بمعنى أننى بدأت من قمة السلم، ولذلك كنت أرى الكثير مما قرأته بعد «شكسبير» عادياً، كما أننى تربيت على شغل كبار غيره.
رحلة الأدب العربى
قرأت لطه حسين، وزكى نجيب محمود، وقرأت لعدد من كتاب المسرح، ألفريد فرج، وميخائيل رومان، وسعد الدين وهبة، ولعبدالرحمن الشرقاوى، وللعقاد، وهو من أمتع القراءات بالنسبة لى، وأراه أديباً رفيع المستوى، وباقرأ له بنهم، وكان مقرراً علينا فى ثانوى كتاب «عبقرية عمر»، ورغم صعوبته على باقى الطلبة، لكننى كنت أحبه كثيراً. وقرأت لطه حسين، بالإضافة إلى قراءة ما كتبه الأساتذة الذين تربينا على أيديهم، نجيب محفوظ، يوسف إدريس ومحمد عبدالحليم عبدالله، وكل هذه الثقافة تملأ زاد الكاتب، أو تعتبر ذخيرته، التى يحارب بها. وهذا ما تربى عليه جيلنا، وتعلم منه. بشكل عام الثقافة الواسعة تحل للسيناريست الكثير من المسائل، وتجعله يتخطى مشكلات الورق، لأنه سيجد الحلول دائماً بناءً على ثقافته، التى ستأتى له بصورة تلقائية وطبيعية.
الخيال نعمة
إنك تحلم، تتأمل الأشياء، تتخيل، يعتبر نعمة من الله، فلولا الخيال ما كنا وصلنا إلى القمر، ولولاه ما كنا اخترعنا القطار، فيجب أن يكون خيال السيناريست واسعاً جداً، بجانب وجود الثقافة الواسعة.
الضحكة والدمعة فى جرعة واحدة!
لم أذهب إلى معهد السينما، ولم يعلمنى أحد كتابة السيناريو، لكن بمجهود ذاتى قرّرت أن أعرف كيف يُكتب السيناريو، بحثت عن «الكتالوج»، لكن قبل طريقة الكتابة، توجد رغبة جامحة تقودك لفتح «الكتالوج»، لأنه وحده لا يعطيك الإحساس، لكنه يعرفك الطريقة فقط، فسهل جداً أن تعرف القواعد، ولكنها ليست شرط الجودة، لكن الشرط هو معايشة الناس.
أنا عندما أقول إننى حضنت مسرحيات شكسبير قبل كتابة الحوار، فأنا لم أنقل حواره، وإنما كتبت بطريقتى، من خلال خبراتى، من خلال جملة شعبية سمعتها على مقهى جلست فيه، من عشرتى للناس وأنا راكب معهم التروماى، ومن داخل الأوتوبيس، اختزلت الـ«أفشة» بداخلى، ومن خلال المعايشة عرفت كيف يتصرّف الناس، كيف تخرج الضحكة والدمعة، فأنا أقوم بتحويش المواقف، ثم عرضها على المشاهد جرعة واحدة. لا يستطيع أى شخص الكتابة عن الناس، إلا إذا عايشهم، على سبيل المثال أستاذنا نجيب محفوظ، ليس لديه أى عمل عن الفلاحين، وأذكر أنه جاوب عن هذا السؤال، لا أتذكر إن كنت أنا الذى سألت أم شخص آخر فى إحدى ندواته:
- ليه يا أستاذ ماكتبتش عن الفلاحين؟
وكان رد «محفوظ» العبقرى:
- أنا ماعشتش فى الفلاحين، وبالتالى ماعرفش أكتب عن الفلاحين.
بينما عبدالرحمن الشرقاوى عاش فى الفلاحين فكتب عنهم، مثل «الأرض» وخلافه، ومحمد عبدالحليم، ويوسف إدريس فى القرية والمدينة، إذن المعايشة شىء مهم جداً.


نصيحة يوسف إدريس: مكانك هنا
كتبت القصة القصيرة، والمجموعة بالفعل تم الموافقة عليها، وقتها على ما أتذكر كان عمرى 20 عاماً أو 21، وصدر لى «القمر يقتل عاشقه» عن الهيئة العامة للكتاب، لكن عندما قرأت المقالات النقدية بعدها، لم أجد أى سيرة عن مجموعتى فيها، أو كانت تأتى سيرتها فى آخر الصف، فعلمت أن فى مجال القصة القصيرة يوجد من هو أفضل منى، وأكثر تميّزاً، أو يتم تصنيفه ككاتب قصة قصيرة، خاصة أن النقاد وقتها لم يكونوا رحماء فى نقدهم، كان هناك ناقد اسمه فاروق عبدالقادر، شديد القسوة، يجرح فى نقده، وطالما لم أجد صدى طيباً عند النقاد، كان يجب على أن أنصرف أو أتحول.
وفى إحدى المرات قابلت يوسف إدريس فى مطعم، قبلها كنت قد أرسلت إليه المجموعة لكى يقرأها، وكان من الواضح أنها لم تعجبه، وقال لى ونحن جالسان: «بص وراك»، وسألنى بعدها: شايف إيه؟ فنظرت خلفى وقلت له: «تليفزيون».
فقال لى وهو يلوح بيده إلى التليفزيون: «مكانك هنا، أنت هتعرف تكتب دراما كويس جداً».
وبالفعل هو ما حدث، هو «لقط شىء ما»، أنا لم أكن أراه فى نفسى، ووجّهنى إليه، والشىء الذى لم أكن أفهمه أو غير مكتشفه فى ذاتى، هو اكتشفه وحدده لى. بالفعل بعدها رُحت التليفزيون ودخلت المبنى والإذاعة، وبعد تنفيذ نصيحته أدركت أن الله خلق البشر مختلفين، كل واحد لديه منطقة ما ينجح فيها، لا يوجد أبداً شخص مثل الآخر.
القاهرة بعد الساعة 2 بالليل.. تحقيق صحفى
عملت فى الصحافة عام 1974 مع لويس جريس رحمه الله، فى «روزاليوسف»، وقال لى وقتها:
- بما أنك فنان، فستلتحق بقسم الفن.
قلت له:
- لأ، لأنى لن أستطيع التوقف عن كتابة السيناريو، بالتالى لو كتبت فى قسم الفن، لن أستطيع توجيه النقد أو الإساءة لأى زميل، ومن ثم لن ألتحق بقسم الفن.. ورفضت ذلك الأمر.
وبالفعل انتقلت إلى قسم التحقيقات، وكان رئيسى وقتها منير عامر، وقال لى:
- أنا عارفك صايع، عايزك تعمل لى موضوع عن القاهرة بعد الساعة 2 بالليل، أو موضوع عن المتحف المصرى.
استغرقت أسبوعاً كى أقوم بعمل التحقيق الصحفى، ثم عُدت للأستاذ منير واعتذرت له فى ما بعد عن المجلة كلها، أنا فى هذا الوقت كنت منشغلاً بالكتابة فى المسرح والإذاعة، يعنى «الدنيا كانت منورة معايا».
إلى أن جاء حادث اغتيال فرج فودة، تأثرت بشدة، وكتبت مقالاً واستعرت عنوانه من مسرحية شهيرة كنت قرأتها اسمها «استيقظوا أو موتوا»، واتصلت بعادل حمودة، ولم يكن صديقى، والمقالة عملت «بُم»، بمعنى أحدثت صدى كبيراً جداً، لأننى كتبتها بقلب، ومن هنا جاءت فكرة الكتابة فى الصفحة الأخيرة فى «روزاليوسف»، وبعدها كتبت مقالات، لكن عمرى ما تقاضيت أى أجر عن مقال كتبته، لأن المقال يعتبر رأياً أكتبه، والرأى لا أحصل على ثمن مقابله، وهذه قناعتى الشخصية.
القرية والنشأة والقراءة على المصطبة
فى القرية كنت مضطراً للقراءة، لا يوجد ما أفعله فى مركز منيا القمح سوى قراءة الروايات، فكان لدىّ فراغ كبير جداً، فكنت أجلس على المصطبة طوال النهار، وفى يدى كتاب، فكانت القراءة شاغلى، وكنت أعشقها.
العشق والكتابة وسكك الحياة
الكثير من الناس لديهم موهبة الكتابة لكن الحياة أخذتهم إلى سكك أخرى، والفارق هنا هو حالة الحب، والعشق بين الشخص والكتابة، والذى يجعله غير قادر على الاستغناء عنها، والذى يعشقها بحق، يبدأ فى أن يكون نفسه ولا يقدر على الاستغناء عنها، ولا يذهب إلى سكك أخرى مع الحياة. «يعنى المسألة عشق، إيه اللى يخلينى وأنا طالب فى ثانوى فى الزقازيق، أشترك فى مسابقة نادى القصة، وأسافر من الزقازيق وكانت تذكرة القطار وقتها 17 قرشاً، لأقدم فى نادى القصة فى شارع قصر العينى، وأتحمل هذا المجهود؟ السبب هو العشق، الشغف، «إيه اللى يخلينى أدور على ندوة الأستاذ نجيب محفوظ وأتلهف لحضورها»؟، فالكتابة كانت فى دمى».
دراسة السينما ذاتياً
بالنسبة للكاتب، ليس شرطاً أن يدرس السيناريو، هل يوسف إدريس درس شيئاً له علاقة بالكتابة، بالعكس كان طبيباً، بشير الديك درس التجارة، وأنا لم أدرس سيناريو، لكن الدراسة تكون ذاتية، فإذا كتب عليك أن تكون كاتب سيناريو، عليك أن تعرف كيف يكتب، وذلك يحدث بقراءة نماذج لسيناريوهات، تدرسها وتتعلم منها، أو أن تقرأ الكتب المختصة بهذا الفن، وتذاكرها وتقوم بتجهيز نفسك، والذى من المفترض أن تدرسه فى المعهد، تدرسه بحريتك، بدون تعديلات من أحد، عليك أن تقوم بتزويد وقودك وكفاءتك بنفسك.
القواعد السينمائية.. وكسرها
القواعد وضعت لكى يكسرها الخيال، «هو إحنا لو مشينا على القواعد كانت الدنيا هتبقى كده؟».. الإجابة لا.
فيجب أن نبتكر، لذلك أنا حريص جداً على حضور المهرجانات السينمائية، وكنت أسافر كل عام لمهرجان «كان»، وأشاهد 5 أفلام يومياً، من اتجاهات مختلفة، وأشاهد كيف تحدث النقلة، وأذهب من مكان لآخر، لأعرف كيف تتغير الحياة وتتطور وتسير، وكنت أتابع التطورات الجديدة، وكل تلك المشاهدات كانت تترك أثراً لدىّ ويأتى مردودها فى كتاباتى، وكنت دائم التطور مع التطور، لم أتوقف ولم أتجمد فى مكانى.
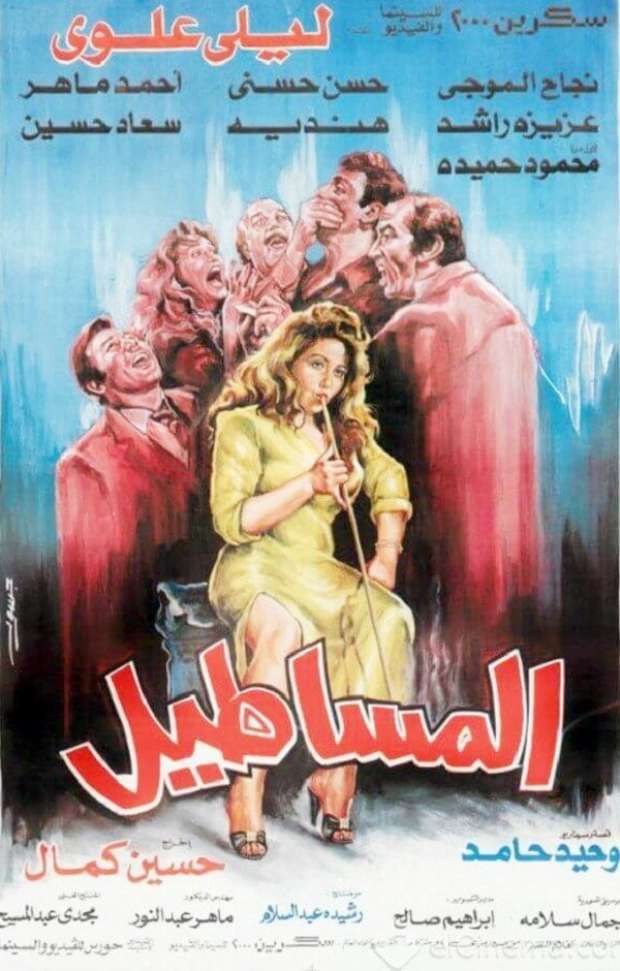
استقلالية المؤلف
على السيناريست أن يحترم ذاته، وألا يقدم تنازلات، الليونة مطلوبة، وأى إنسان ليس على صواب فى كل الحالات، لكن لا يسمح بالإهدار، وإذا طلب أى شخص من الكاتب شيئاً ما غير صحيح، فعلى السيناريست أن يرفض، ولا يتنازل، لأن تقديم تنازل واحد سيعقبه العشرات من التنازلات فيما بعد، فشخصية المؤلف يجب أن تكون لاصقة به منذ البداية.
الحكاية دائماً تبدأ من المؤلف، الكاتب هو الأصل، صاحب الرؤية والفكرة، وهو القادر على أن يحافظ على كيانها، الأمر بيده، هو الذى يرفض أو يقبل، يقول آه أو لا، من الخطأ أن يفرض عليه سواء كان ممثلاً أو مخرجاً أى شىء فى هذه الحكاية.
يا سابع أرض يا سابع سما.. اختار
كون أن السيناريست نجح، سيؤدى ذلك إلى وجود احتمالين، الأول: «يا ينزل سابع أرض»، ذلك فى حال إصابته بالغرور، ووقتها يكون قضى على نفسه.
والثانى: «يطلع سابع سما»، وهنا يجب أن يكون لديه سؤال دائم وهو القادم ماذا سيكون؟، أفضل أم أسوأ، سيتقدم للأمام أم سيعود للخلف ودائماً يفكر فى الخطوات التالية بحياته المهنية. الفنان الحقيقى لديه حالة قلق مستمرة طوال الوقت، لأنه يريد تقديم الأفضل، ولديه إخلاص شديد للكتابة، لكن أنا قابلت فى طريقى أناساً أصيبوا بالغرور، فسقطوا وليس لهم أى أثر أو وجود الآن.
إحنا بنشتغل عند الناس
الكاتب لا يعمل عند مخرج ولا ممثل، إحنا «بنتشغل» عند الجمهور، وأنا أكتب عن قضايا الناس، وأعمالى نجحت ولمست الناس، ولاقت صدى طيباً حتى هذه اللحظة، لسبب بسيط لأنى «واخدها» منهم، لم أكذب عليهم، ولم أزيّف الواقع، ولا أتاجر بقضية ولم أدنس قضية، ولم أبتز أحداً.
ومن الثوابت أن تخلص للموضوع الذى تكتب عنه، ولا يجوز أن يمسك الكاتب العصا من منتصفها، ويجب أن يعبر عن وجهة نظره التى يراها بكامل إرادته، ويكون لديه القدرة على إقناع الآخرين بالفكرة التى يؤمن بها.
مدمن حضور الأفلام
أنا مدمن سينما من أيام الزقازيق، كنت أقطع تذكرة صالة ثمنها 7 أو 3 صاغ، فى سينما سلمى، ومصر، وأمير والوطنية، وكانت وقتها بـ9 مليمات ترسو، ويعتبر دخلت جميع الأفلام التى عرضت فى الزقازيق، فأنا متربى على الثقافة السينمائية بشكل مبكر. بعدها كنت أذهب متلصصاً، لأشاهد أفلامى التى كتبتها وغيرها، كانت التذكرة تساوى 3 جنيهات، وعندما كنت أجلس وسط الجمهور، وأسمع تعليقاته، تعلمت حكاية مهمة جداً.. أن المشاهد إذا سبق الشاشة وتنبأ بالذى سيحدث، تبقى الحكاية فاشلة، وصناع العمل فشلوا. وأحياناً تشاهد العمل وسط الجمهور وتفاجأ بمن يسبق بجملة حوار: «يقول البطل هيقول كذا، تعرف أن المسألة فشلت»، لأننا نقدم للمشاهد الدهشة، طالما فُقدت، لماذا سيكمل المشاهد جلوسه فى السينما؟ إذن توجد مشكلة.
المزاج والكتابة
الكتابة أمر مزاجى بحت، لو شخص عكر المزاج، فكيف سيكتب؟ كما أنى لا أجيد الكتابة إلا فى الأماكن العامة، وهى عادة شخصية، أنا تربية فلاحين، كنت أستيقظ فى الخلاء الواسع، أنظر للمياه وفرع النيل الذى كان يمر أمام قريتنا، فلاح تربى على الزرع، وأنا طفل لم يكن هناك كهرباء، كنت أذاكر على لمض الجاز، وفى حال إضاءتها كان يهجم الناموس، فلم يكن فى استطاعتى المذاكرة مساء، فكنت أستيقظ فجراً، أسير على الزراعية، وأذاكر على ضوء ربنا، وأبعد عن الناموس، فتعودت حتى الآن أن أستيقط مبكراً وأذهب فى الخلاء، مثل المكان الذى أجلس فيه الآن (ردهة واسعة بأحد فنادق القاهرة مطلة على النيل)، ولا أجيد الكتابة لو كنت فى غرفة داخل المنزل وخلال فترة من عمرى كنت أنزل ليلاً أجلس على مقهى أم كلثوم فى التوفيقية، وأكتب عليها مساءً.


السينما والتعبير بالصورة
فى كتابة السيناريو، الفيلم يختلف عن المسلسل، والفيلم القصير غير الفيلم الطويل، وسيناريو الفيلم يعتمد اعتماداً كلياً على الصورة، وعندما كنا نقوم بتعريف السيناريو بالنسبة للسينمائيين كنا نقول هو فن الحكى بالصورة، أى إن جملة الحوار تكون فى أقل القليل، لا تستعمل إلا فى ساعة الضرورة، فكل شىء ممكن أعبر عنه بالصورة، يبقى استعمل الصورة.
صاحب دكان كبير فى شارع المؤلفين.. فلماذا الإخراج؟
جاءتنى أكثر من فرصة بالفعل، لكن رفضت تماماً هذه الحكاية، لأن المسألة ليست شطارة، عن نفسى الإخراج لا يضيف لى شيئاً، إنما ما يضيف لى هو أن أكون كاتب سيناريو ناجحاً، وليس مخرجاً، فأنا حسبتها صح، قلت أنا صاحب دكان كبير فى شارع المؤلفين، فلماذا أفتح «كشك» فى شارع المخرجين؟
لو كنت مخرجاً سيكون هناك من هو أفضل منى مثل: عاطف الطيب، سمير سيف، حسين كمال، مهما فعلت.. فالإخراج ليس بداخلى ولا أريده.
لكنى كنت دائماً حريصاً على اختيار المخرج، وتكون لدىّ ثقة مطلقة فيه، وإذا وجد أى مشكلة يقوم بالاتصال بى، لكنى لا أذهب إلى مواقع التصوير، إلا فقط لإرسال الورد مثلاً، تورتة، مجرد التهنئة بالعمل.
وبالنسبة للمخرجين فالأستاذ سمير سيف، هو أكثر مخرج عملت وارتحت معه، إنسان شديد الثقافة، أستاذ فى المعهد، خواجة بمعنى سلوك الخواجة، رجل شديد الاحترام.





0 تعليق